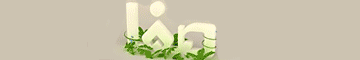المقـدمـة
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الهادي الأمين، نبينا محمد، وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واتبع سنته إلى يوم الدين.
أما بعد :
فإن نقد مقالات المبتدعة وأعمالهم ومسالكهم، والرد عليهم، وكشف ما عندهم من باطل، والتحذير من زيفهم، وظيفــة العلمــاء، لا يجوز التساهل فيها، أو التقصير في أدائها، إذ بها تتم حماية الدين ونقاوته من شائبة الباطل، وقد أكمل الله دينه، وأتم نعمته، ورضي الإسلام الذي جاء به محمد صلى الله عليه و سلم دينًا، قال تعالى : (اليوم أكملتُ لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينًا) (المائدة : 3). وقال تعالى : (وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا) (الحشر : 7). وقال صلى الله عليه و سلم : (مَنْ أَحْدَثَ فِي أَمْــرِنَا هَــذَا ما ليس منه فهو رَدٌّ) (1)، وفي رواية : (من عَمِلَ عملاً ليس عليه أمرُنا فهو رَدٌّ) (2).
قد أقام الله تعالى للعلماء ميزان الحق، الذي يَزِنُون به الأقوال المخالفة، ويصدرون عنه أحكامهم.. أقامه على العلم والعدل : العلم الذي يتبين به الحق من الباطل، وتُقام به الحجة على قائله أو فاعــله، قال تعالى : (ولا تَقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسئولا) (الإسراء : 36)، والعدل الذي يثبت به لكل ذي حق حقه من مدح أو ذم غير مغموط فيه، ولا متعتع، وبقدر متساوٍ مع الأولياء والأعداء، قال تعالى : (يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على أن لا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى) (المائدة : 8).
ويُعد شيخ الإسلام ابن تيمية عَلَمًا من أعلام الدين، وإمامًا من أئمة الهدى، نَافَحَ بلسانه وقلمه عن السُّنَّة، وجاهد بنفسه رؤوس الفتنة، ووقف موقف الأبطال من دعاة البدعة، وصبر على ما لاقاه في سبيل إعلاء كلمة الله من العَنَت والمحنة، فلم تَلن له قناة، ولم تهن له عزيمة، حتى أظهر الله بعلمه وجهاده ومواقفه منهج أهل السنة، ونشر على يديه عقيدتهم، بعد أن كانت الغلبة في عصره لعقائد أهل الكلام، والرواج لأقوال أهل الابتداع.
واعتمد ابن تيمية في كل ما خاض الناس فيه من أقوال وأعمال في أصول الدين وفروعه، على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه و سلم، غير متبع لهوى، أو مقلد لأشخاص، فإن الله ذم في كتابه الذين يتبعون الظـن وما تهوى الأنفس، ويتركون اتباع ما جاءهم من ربهم الهدى، قــــال الله تعالـــــى : (إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى ) (النجم : 23)، وأقام العدل في حكمه على أقوال الناس وأعمالهم، وإن كانوا من المخالفين له في الأصول، مراعيا ما يسوغ فيه الخلاف، أو ما يقع فيه خطأ بسبب اجتهاد، أو تأول صحيــح، أو ما يلائمه التماس العذر للمخالف، فإن ذلك أسلم من الوقوع في الظلم الذي حرمه الله تعالى على عباده، أو القول على الله بغير حق، وذلك أقرب للتقوى.
فكان ابن تيمية قائمًا بميزان الحق، الذي صرَّح بوجوب الوزن به، وأنه الحد الفاصل بين منهج أهل السنة والجماعة، ومنهج أهل البدع والغواية في الكلام على الناس، قائلاً : (والكلام في الناس يجب أن يكون بعلم وعدل، لا بجهل وظلم، كحال أهل البدع) (3).
ذلك أن الأصل حفظ جارحة اللسان من القول إلا حقًا، وحماية أعراض الناس من انتهاكها زورًا وبُهتانًا، قال صلى الله عليه و سلم : (مَن كانَ يؤمنُ باللهِ واليومِ الآخرِ فليتَّقِ اللهَ وليَقُلْ حقًّا أو ليَسْكُت) (4)، وقال صلى الله عليه و سلم : (بِحَسْبِ امرئٍ من الشرِّ أن يَحْقِرَ أَخَاه المسلم، كلُّ المسلمِ على المسلم حَرام، دَمُهُ ومالُهُ وعِرْضُه) (5).
وقد حرَّمَ الله سبحانه أذية المؤمنين، أو إساءة الظن بهم أو غيبتهم، فقال سبحـانــه : (والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانًا وإثمًا مبينًا ) ( الأحــزاب : 58 ). وقال تعالى : (يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرًا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضًا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتًا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم) (الحجرات : 12)، وعَظَّمَ القول في المسلم بغير علم، مرشدًا إلى إمساك اللسان عن الخوض في عرضه بغير حق، وموجهًا إلى تبرئة ساحته مما قيل فيه، إبقاء على الأصل : وهو عدالته من الجارح، وسلامته من القادح، قال تعالى : (إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينًا وهو عند الله عظيم ولولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك) (النور : 15_16).
إن اعتماد العلم والعدل شرطان في الكلام على الناس عمومًا، وفي الحكم على أقوال المخالفين وأعمالهم خصوصًا.. لا يعني المداهنة مع المبتدعة، ولا الدفاع عن باطلهم، ولا تذويب العقيدة أو إضعاف جانبها أمام الضلالة، أو التقصير نحو إظهارها أو إعلائها على غيرها من الأقوال والآراء المخالفة، لكنه المنهج الحق الذي شرعه الله لأنبيائه وعباده، وارتضاه لهم في كتبه، واتبعه رسوله صلى الله عليه و سلم، وسار عليه سلف الأمة وعلماؤها.. يقول عنه شيخ الإسلام ابن تيميــة بعد تقريــره : (ولما كان أَتْبَاعُ الأنبياء هم أهل العلم والعدل، كان كلام أهل الإسلام والسنة، مع الكفار وأهل البدع، بالعلم والعدل لا بالظن وما تهوى الأنفس) (6).
يستهدف هذا المنهج ضبط الأحكام، لتصدر بعد تحر وتثبت، وصيانتها من الانسياق مع جواذب الأهواء، وسلامتها من الجهل على الناس وبخسهم حقوقهم.. ويتحقق هذا المنهج في صياغة أصول كلية قائمة على الأدلة المعتبرة، يرجع إليها من احتاج الكلام في الناس، والحكم على أقوالهم وأعمالهم كلما اقتضت الحاجة، تفاديًا لما ينشأ عن الجهل بها من مفاسد وعظائم لا تخفى.
ومن يراجع كتب شيخ الإسلام ابن تيمية ورسائله، يصل إلى نتيجة واضحة، هي تمكُّنه من تحديد هذه الأصول، التي كثيرًا ما كان يشير إليها بحسب ما يقتضي المقام، عند حواره ومناقشته ورده على مقالات المبتدعة وأعمالهم، والتي ساعدته على وحدة أسلوبه واستواء أحكامه.. وقد أبان رحمه الله، أهميتها، فقال : (لابد أن يكون مع الإنسان أصول كلية يرد إليها الجزئيات، ليتكلم بعلم وعدل، ثم يعرف الجزئيات كيف وقعت، وإلا فيبقى في كذب وجهل في الجزئيات، وجهل وظلم في الكليات، فيتولد فساد عظيم) (7).
إن أهمية هذه الأصول تتلخص في أمرين :
الأول : أنها قاعدة الوصول إلى أحكام دقيقة ومنضبطة ومنصفة، مبنية على العلم والعدل، وملتزمة بالمنهج الحق.
الثاني : أنها سبيل الوقاية من التخبط في الأحكام على غير هدى، وما يتولد عنه من أضرار كبيرة ومفاسد عظيمة، تلحق بالأفراد والجماعات.
لهذه الأهمية، رأيتُ جمع هذه الأصول المتناثرة في مواضع مختلفة من مؤلفات شيخ الإسلام ابن تيمية، لكي يسهل الانتفاع بها والرجوع إليها، وقد حافظتُ على نصها، معتمدًا على النقل من مظانها، ومجتهدًا في ترتيبها على حسب مراده منها، باذلاً غاية جهدي في التعرف على الأصول التي اعتمدها في الحكم على المبتدعة والكلام فيهم، ولا أقول : إني استطعتُ الإحاطة بجميعها أو الإلمام بأجزائها، ولكن حسبي أني جمعت ما تيسر لي منها مما أمكنني الوقوف عليه.
والله أسأل أن يلهمني رشدي، وأن يرزقني صوابًا في القول والعمل، والله وحده الهادي إلى سواء السبيل.
د. أحمد بن عبد العزيز الحليبي