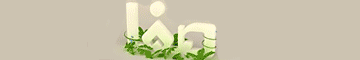كواشف زيوف
د/عبدالرحمن حبنكة الميداني
( يلاحظ الباحث الناظر في أنواع الحكم الديمقراطي وصوره مايلي:
أولاً :
أن التزام هذا الحكم بإعطاء الشعب سلطات التشريع والتقنين والتنظيم كلها ، دون أخذ شريعة الله المنزلة أولا، يجعل الدساتير والقوانين والتشريعات خاضعة لأهواء الكثرة من الشعب ، أو لأهواء الذين انتخبهم الشعب ليعبروا عن إرادته ، أو يكونوا وكلاءه.
فنجم عن ذلك تشريعات إباحة نشر الإلحاد والكفر بالله في الدول الديمقراطية، لأن أكثر الشعب أو أكثر المنتخبين من قبل الشعب يرغبون في ذلك ، و تشريعات إباحه الزنا القائم على تراضي الطرفين ، ولو كان ذلك في الشوارع العامة والحدائق العامة ، وعلى ضفاف الأنهر دون توار أو تستر . وإباحه اللواط ، وجعله عملا يحميه القانون ما دام قائما على تراضى الطرفين ، حتى أقرت بعض هذه النظم أن من حق الذكر أن يعقد عقده على ذكر آخر كما يتم الزواج بين رجل وامرأة . وإباحه سائر المشروبات الكحوليه ، لأن أكثرية الشعب ترغب بذلك . وإقرار الربا وما تكتسب به من حقوق , وإقرار القمار ، وكثير من الحريات الشخصيه المهلكة , لأن أكثرية الشعب تريد بذلك .
فمبدأ الديمقراطية : أن الشعب هو الذي يحكم نفسه بنفسه لنفسه . فهو صاحب السلطة في وضع الدستور وكل القوانين والشرائع والنظم
وانتشر بسبب ذلك فساد عريض في الأرض . وهذا الفساد المنتشر منذر بدمار ماحق لهذه الشعوب .
ثانيا :
لما علمت شعوب الديمقراطية أنها هي صاحبه السلطات كلها ، أرادت أن تمارس حقها . فاتجه كل الطامعين بالسلطة ، من المؤهلين للحكم وغير المؤهلين وكل أصحاب الأهواء والشهوات والنزاعات والنزغات يعملون بكل ما أوتوا من ذكاء خبيث وحيله شيطانيه للوصول إلى الحكم ، وانطلقت في مضمار الحيل أساليب خداع الجماهير ، وتزوير إرادتهم ، بكل عمل غير أخلاقي .
وصارت السياسة والعمل فيها صورة جامعه للكذب , والخداع ، والنفاق ، وإطلاق الافتراءات ، وتجريح الآخرين بغير حق، وطلبا للمنافع والمصالح الخاصة ، وصراعات شخصية وحزبية ، بغيه الوصول إلى الحكم لتحقيق المنافع الشخصية ، والأهواء ، والشهوات ، والعلو في الأرض .
وأسست الأحزاب كي يمارس الشعب الديمقراطية ممارسة منظمة ، وقامت بينها الصراعات والصدامات ودبت بسبب ذلك الفوضى في كثير من البلدان .
وتعرضت الأحزاب لشراء ضمائرها أو ضمائر زعمائها من قبل أصحاب الأهواء والمصالح ،من الداخل أومن الخارج ، ثم لما وصلت إلى الحكم وجدت نفسها مضطرة لتحقيق أهواء ومصالح الذين اشتروا ضمائرها ، على خلاف مصلحه الشعب الذي أوصلها بأصواته إلى سدة الحكم .
وبعض هذه الأحزاب حققت مصالح المنظمات اليهودية العالمية التي اشترت ضمائرها ، أو مصالح الدول الاستعمارية التي اشترت ضمائرها ، أو مصالح طبقة خاصة من طبقات الشعب كالرأسماليين أو غيرهم حينما وصلت إلى سدة الحكم .
وكانت التنظيمات الحزبية الديمقراطية المخادعة للشعب بالأكاذيب والتضليلات والوعود التي لايراد تنفيذ شيء منها ، بمثابة قناع ديمقراطي تم عن طريقه تزوير إرادة الشعب ) .
- (للديمقراطية مثالب كثيرة ، منها مايلي :
أولا :
لا تنظر الديمقراطية إلى حقوق الله على عباده ، ولا تنظر بعدل إلى الحقوق العامة ، وحقوق المجتمع على الأفراد ؛ فهي منحازة بإسراف لجانب الفرد وإطلاق حريته .
ثانيا :
تخضع الديمقراطية لدى وضع الدستور والقوانين والنظم لأهواء أعضاء المجالس النيابية ، واللجان التي تفوض في وضعها ، أو وضع مشروعاتها.
وغالباً ما يحرك هذه المجالس أفراد معدودون ، ويوجهونها حسب أهوائهم ، بوسائلهم أو أحابليهم الشيطانية .
وتظفر بنصيب الأسد فيها غالباً بعض الطبقات الاجتماعية ، التي تسخر التطبيقات والمؤسسات الديمقراطية لصالحها ، أو يظفر بنصيب الأسد فيها الأفراد المحركون لها والموجهون لمسيرتها وآرائها ومناقشاتها .
وتتدخل عناصر ( الحيلة ، والذكاء ، والمال ، والشهوات ، ومطامع المناصب ، وشراء الضمائر ، وتزوير إرادات الجماهير بأساليب شتى ، في استغلال المجالس ، وتجميع الأصوات ، وتحريك الجماهير الغوغائية ، والتغشية على الأفكار والبصائر ، وإبعاد كل رأي صحيح عن مجال رؤية الجماهير له ، وصناعة الضجيج الإعلامي المشوه بالحقائق والمزيل للباطل ؛ لإقرار المواد الدستورية أو القانونية أو التنظيمية التي تحقق مصالح أصحاب الأهواء الشياطين الماهرين بأساليب استغلال التنظيمات الديمقراطية ومؤسساتها وتطبقاتها .
ثم لأنواع المكر والكيد التي تمارسها الأحزاب السياسية الديمقراطية تأثير كبير في جعل الحق باطلاََ ، والباطل حقاَ ، وخداع جماهير الذين يدلون بأصواتهم ، للموافقة على مشاريع الدساتير والقوانين والنظم ، أو انتخاب الذين يتحملون الأعباء التشريعية أو الإدارية. هذا إذا لم يتم تزوير الانتخابات بتبديل الصناديق التي ألقى المخترعون فيها أوراق انتخاباتهم ، بصناديق أخرى مشابه لها في الظاهر ، وما في باطنها مزور تزويراً كلياً .
وكم حدث هذا في مزاعم انتخابات ديمقراطية وكانت الحصيلة " مئة في المئة " لصالح المزور أو الآمر به ، أو " 9، 99% " أو نحو ذلك !
ثالثاً :
أن الديمقراطية باعتبارها تنادي بأن الدين لله وأن الوطن للجميع ، وأن شأن الأقليات في الدولة كشأن الأكثرية في الحقوق والواجبات ، تمكن الأقليات من التكاتف والتناصر لاستغلال الوضع الديمقراطي ضد الأكثرية ومبادئها وعقائدها ودينها ، وتمكنها أيضاً من التسلل الى مراكز القوى في البلاد ، ثم إلى طرد عناصر الأكثرية رويداُ رويداُ من هذه المراكز بوسائل الإغراء، وبالتساعد والتساند مع الدول الخارجية المرتطبة بالأقليات ارتباطاً عقدياً أو مذهبياً أو سياسياً أو قومياً ، أو غير ذلك.
وتصحو الأكثرية من سباتها بعد حين ، لتجد نفسها تحت براثن الأقلية ، محكومة حكماً دكتاتورياً ثورياً من قبلها ، مع أنها لم تصل إلى السلطة إلا عن طريق الديمقراطية .
لقد كانت الديمقراطية بغلة ذلولاً أوصلت أعداء الأكثرية وحسادها والمتربصين الدوائر بها إلى عربه ثيران ديكتاتورية الأقلية .
رابعا :
الديمقراطية وفق مبادئها المعلنة حقل خصيب جداً لتنمية أنواع الكذب ، والخداع ، والمكر، والحيله ، والكيد ، والدس الخبيث ، والغش ، والخيانة ، والغدر ، والغيبة ، والنميمة ، والوقيعة بين الناس ، وتفريق الصفوف ، ونشر المذاهب والآراء الضاله الفاسدة المفسدة ، إلى سائر مجمع الرذائل الخلقية الفردية والجماعية . لتتخذ هذه الرذائل وسائل وأحابيل للشياطين ، حتى يستاثروا بكل السلطات في البلاد ، وكل خيراتها وثرواتها ، وحتى يتمكنوا من مطاردة الدين وأنصاره وحماته والمستمسكين به ، وإماتة الحق والخير والفضيلة .
خامسا :
الحريات الشخصية في الديمقراطية حريات مسرفة ، تفضي إلى شرور كثيرة ، وانتشار فواحش خطيرة في المجتمع . ومآلها إلى الدمار الماحق.
سادسا :
الحريات الاقتصادية في الديمقراطية مسرفة تفضي إلى عدوان المحتالين على حقوق الشرفاء ونشر الاستغلال والاحتكار ، وحيل سلب الأموال ، وتمكين الغشاشين والمقامرين والمرابين والمحتكرين والراشين والمحتالين ومستغلي السلطة الإدارية أو العسكرية ، من تحقيق مكاسب مالية وفيرة ، بالظلم والعدوان وهضم الحقوق ، واكل أموال الناس بالباطل ، والغلول في الأموال العامة .
سابعا :
حق كل مواطن في المساواة السياسية في الحكم ، دون شرط الإسلام والعدالة الشرعية والأهلية للمشاركة في الرأي أو المساهمة في الاقتراع أو الانتخاب والاختيار يفضي إلى نسف دعائم الدولة الإسلامية ، وجعلها علمانية غير دينيه ، أو تمكين الأرذال من اعتلاء سلطة الحكم ، وتحويل الدولة إلى دوله فساد وإفساد وفسق وفجور وفحش فى الأقوال والأعمال ، وشر كبير .
وقد يلعب أعداء الأمة بالجماهير غير الواعية ، فيركبون ظهورها ويصلون بذلك إلى حكم الشعب رغم إرادته عن طريق تزوير إرادته نفسها.
ثامنا :
حق الفرد في ترشيح نفسه للحكم في الديمقراطية يجعل طلاب مغانم الحكم يتنافسون عليه ، ويتقاتلون من أجله ، ويسلكون مسالك كثيرة غير شرعية للوصول إليه ، ويبذلون أموالاً طائلة ، أملا بأن يعوضوها أضعافا مضاعفه متى ظفروا بالحكم .
هذه بعض مثالب الديمقراطية ، ويمكن استخراج مثالب أخرى لها ، قد يهتدي إليها الباحث المنقب المجرب ) .
( المرجع : " كواشف زيوف " للدكتور عبدالرحمن حسن حبنكة الميداني ، ص 695-697، 707-710) .
يتبع....